قد تكون رواية واسيني الأعرج “ليليات رمادة” الصادرة حديثاً في جزءين عن دار الآداب، الرواية العربية الأولى، التي تدور في مناخ وباء كورونا الذي هز العالم، وبدا أشبه بالصدمة الما بعد الحداثية، التي أسقطت القناع عن حضارة الوهم التكنولوجي والعلمي والطبي… وفي موازاة الوباء الجرثومي سعت الرواية إلى فضح آثار الوباء السياسي والاجتماعي والظلامي الذي يفتك بالجزائر مثلما يفتك بدول العالم الأول والثاني والثالث والرابع، وهلم جراً.
رواية واسيني الأعرج، التي كان مفترضاً أن تصدر في جزء واحد، صدرت في جزأين نظراً إلى ضخامتها (900 صفحة) ، ويحمل كل منهما عنواناً ثانوياً، وهما: “تراتيل ملائكة كوفيلاند”، و”رقصة شياطين كوفيلاند”. تنطلق الرواية مكانياً من الجزائر، وتنفتح زمنياً على أزمنة متعددة، بين تداخل وانفصال، ومنها زمن كورونا، وزمن الألفية الجزائرية السوداء، وزمن الفترة الراهنة المضطربة التي تتخبط فيها بلد المليون شهيد…
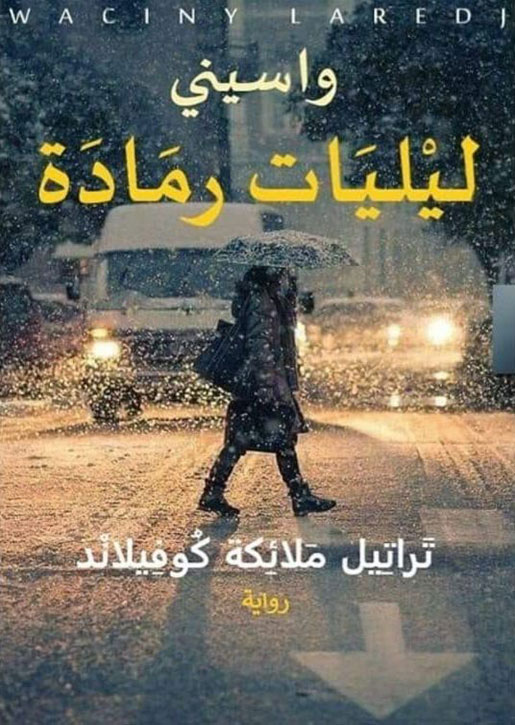
انطلاقاً من روايته الجديدة، يتحدث الروائي واسيني الأعرج عن تجربة خوض عالم كورونا في أبعاده المتعددة، متوقفاً عند مراحل هذه المغامرة الروائية التي سمح لقرائه على “فيسبوك” بأن يتابعوه ويشاركوه الآراء، خطوةً خطوةً. وهذه مبادرة نادرا ما يقبل بها روائي، فهي تتطلب التخلي عن ال”أنا” الذاتية للكاتب وتجعلها “أنا” جماعية.
القارئ كاتباً
السؤال الأول الذي لا بد من طرحه يدور حول نشر واسيني الأعرج فصولاً من روايته “ليليات رمادة” بجزأيها خلال الجائحة جاعلاً القارئ على تواصل معه وكأنه يشارك من بعيد في الكتابة كشاهد طبعاً… هذه ظاهرة فريدة في عالم الرواية العربية، فلماذا اعتمد الروائي هذه اللعبة السردية؟ هل لأن الجائحة كانت من القوة حتى إنه لم يستطع تحملها وحده؟ وهل تدخل القراء في محاورته خلال كتابة الرواية؟ يجيب: “نعم، هي ظاهرة جديدة في الرواية العربية، وفي الكتابة، إذ كثيراً ما كان هذا الفعل ذاتياً وحميمياً، ولا يطلع عليه القارئ إلا عندما ينتهي ويصبح مادة مسوقة. ما حدث معي شيء مرتبط بفعل الموت الذي كان على الأبواب، ولهذا كان لا بد من مقاومة فكرة الموت من أساسها بعدم التفكير فيها، والدخول في فكرة الشراكة مع جمهور قرائي بدأ بسرعة، بكثافة زادت مع الأيام وكأن كل الناس أو الشركاء كانوا ينتظرون من يقوم بالخطوة الأولى، فقمت بها أنا لأنني كنت المعنيّ بالكتابة فقط. لهذا اعتبرتها لحظة خاصة ومتفردة في مساري الإبداعي، أي تحويل فعل الكتابة إلى ورشة. لقد نشطت ورشات كتابية كثيرة في أوروبا وفي العالم العربي، وخرجت بقناعة أن ما قمت به في النهاية كان أكبر ورشة كتابية أشرفت عليها من حيث الامتداد الزمني. دامت أربعة أشهر من بداية الحجر في فرنسا، حتى رفعه، أي أربعة أشهر مُتتالية لم أكن أسمع فيها إلا تقاطع الحروف بحدّة وتداخلها، ثم انفراطها، وأصوات من اشتركوا في اللعبة السردية. وأعتقد أن الجميع خرجوا منتصرين، ولو لوقت، على فكرة الموت المتربص بنا يومياً. كانت الرواية تنشر كل يومي خميس وأحد، وهو أمر لم يكن يترك لي وقتاً للتفكير في شيء آخر غير الكتابة. أهيئ الفصل يوم الأربعاء لينشر الخميس. يوم الجمعة أقضي الوقت في الرد على التعليقات، إذ لم أهمل أي شخص علق ولو بكلمة أو وردة أو سؤال، وكان هذا أحد رهاناتي. يوم السبت أهيئ الفصل اللاحق، يوم الأحد أنشره مساء، أقضي يوم الاثنين في الردود. وهكذا دواليك، أسبوع وراء أسبوع. حتى عملي الجامعي في السوربون كنت أقوم به عن بعد”.
رفقة موسيقى شوبان
ويواصل قائلاً: “كانت أيام الأسبوع تقريباً ممتلئة، ولا فسحة خارج الكتابة. وأنا أكتب طبعاً أستمتع بالموسيقى برفقة ليليات شوبان التي صاحبتني طوال مدة الكتابة، وكانت صحبة ممتعة لأنها لم تعرفني فقط بشكل جديد، على موسيقى شوبان، ولكن أيضاً على حياته المأساوية وعلاقته البائسة مع جورج ساند، وعلى وباء السل الذي كان يتهدده حتى قتله في سن مبكرة. المحاورات مع القراء كانت مفيدة حتماً، لكن أثرها على الرواية كان قليلاً لسبب بسيط، وهو أن الشراكة كانت من خلال التعليقات لشيء أُنجز وكُتب، لكن الليليات منحت للكثيرين فرصة لكتابة ما كانوا يعانونه بسبب الجائحة، وغيرها. اللحظة الجميلة كانت في النهاية. اقترحت أنا، على جميع القراء الذين تابعوا الرواية من الأول للآخر، أن يكتبوا نهاية للرواية كما يفترضونها هم، وكانت اللعبة جميلة وشديدة الطرافة، كانت فيها أغلب النهايات متفائلة. وهو ما لم يحدث معي في النهاية التي كتبتها، إذ جاءت تراجيدية بالمعنى اليوناني للكلمة، لأن البطلة المعالجة للمرضى، أصيبت بـ”كوفيد” الذي ظلت تحاربه بقوة. قرأت كل النهايات ونشرتها، وعلقت عليها حباً في الجمهور الذي كان رفيقي في أجمل تجربة كتابة”.
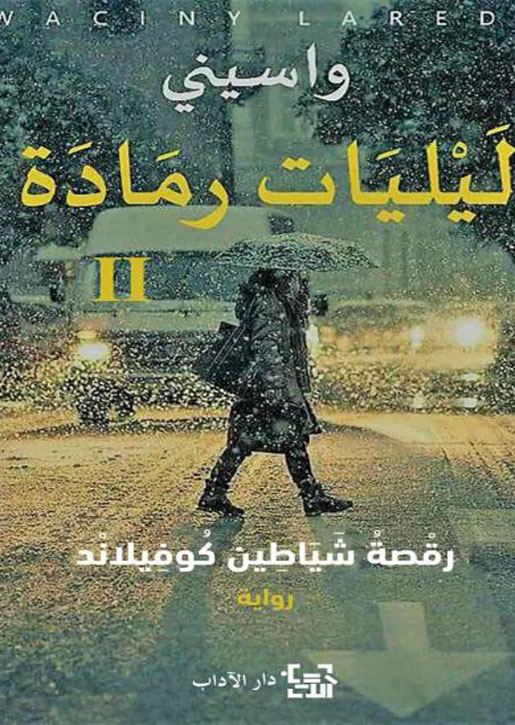
الجزء الثاني من الرواية (دار الآداب)
ويضيف: “عندما أغلقت هذه التجربة نهائياً في الحلقة الثلاثين، فكرت في أن أضع على لسان راما أو رمادة، جملة ظلت عالقة بحلقي: أستطيع الآن أن أموت بعد أن أنهيت مهمتي، لكني في اللحظة نفسها تساءلت، عندما أصبحت “ليليات رمادة” حقيقة، لماذا لا أقول: الآن أستطيع أن أحيا؟ وكانت هذه هي الجملة المفتاح التي تبين انتصارنا على الموت والوباء، ولو بشكل مؤقت، لكن الرواية تحولت وقتها ليس فقط إلى نص أدبي، ولكن أيضاً إلى وسيلة فنية للمقاومة والحياة. المقاومة هنا ليست فقط محاربة المعتدي حتى ولو كان وباءً وجائحة، ولكن أيضاً أن نجعل من الحياة رهاناً كبيراً لا يمكن التنازل عنه، فهي تستحق ذلك. وكان الفراق مع المجموعة صعباً جداً، لكنها لحظة انتصرت فيها الرواية والكتابة والتعليق على الموت المتربص، وكان ربما هذا أهم انتصار. بعدها قضيت وقتاً طويلاً في إعادة تنظيم الرواية لأن النشر في “فيسبوك” يختلف عن النشر في كتاب. الكتاب يستمر في الذاكرة الجمعية، وعمره أطول. لهذا قضيت سنة تقريباً في إعادة تنظيم الرواية وإغنائها، ما جعلها تتغير كثيراً. ونشرت في دار الآداب في جزأين بسبب حجمها الكبير الذي لم أتوقعه”.
تاريخ الأويئة
في مستهل الرواية يضع الأعرج ما يشبه البيان الجائحي تاريخياً وعلى مر العصور، مع الطاعون الأنطوني والطاعون الأسود والجدري، وسواها… ماذا قصد في هذا البيان الجائحي وفي رصده الأوبئة التي فتكت بالشعوب وتسميته المراحل بأسماء مرتبطة بالأوبئة نفسها؟ يوضح الأعرج هذه العودة إلى التاريخ الوبائي قائلاً: “في الحقيقة، إذا غادرنا الرواية قليلاً، وذهبنا إلى المساحات والأماكن التي تدور فيها، يتأكد لنا أن الرواية لم تتوقف على مكان واحد بعينه. صحيح أن الجزائر موجودة في ظل عصابة تحكمت في كل الحياة وبعثرت المال العام، وما زلنا إلى اليوم، لم نسترجع منه مليماً واحداً. حتى وعود الرئيس الجديد باسترجاع المال المنهوب، والتي وسمت حملته الانتخابية، لم تظهر، لكن هذا الوضع، يمس البلاد العربية كلياً تقريباً، حيث الفساد، ونهب المال وتكوين عصابات منظمة ذات ارتباطات دولية حامية لها. هذا المناخ العام هو أيضاً وباء رمزي، وليس فقط الوباء المرضي المعروف. هذا النوع من الوباء نخر البلاد العربية التي لم تستمتع أبداً بخيراتها، ولم تصنع شيئاً يحمي مستقبلها من الهزات. العالم العربي مهدد اليوم بالانقراض، وكل ما يحدث في الثورات والتحولات سياسية، والقضية الفلسطينية، وغيرها، يجب النظر لها في هذا الأفق الأخطر الذي يعمل حالياً على إنهاء الذاكرة العربية الجمعية التي بُنيت على مجموعة من الثوابت التي لم تعد تعني اليوم الشيء الكثير. كل بلد يريد أن يضمن مستقبله بالتحالفات المميتة على الأمد القصير. لدرجة التساؤل القاسي: هل بقي شيء اسمه العالم العربي التي خلقته اتفاقات سايكس بيكو؟ أو الشرق الذي أبدعه الغرب بخرافاته وقصصه عن شرق لم يعرفه أبداً؟ للأسف، كل سنة تقدم لنا لحظة من لحظات الانهيار الشامل الذي يتهدد بلداننا المصابة كلها بهذا الوباء القاتل. وتسمية الحقب بالأوبئة هو جزء من هذه اللعبة الروائية والسياسية. ما ذكرته من أوبئة وتسمياتها، موجودة تقريباً كلها تاريخياً، باستثناء اشتقاقات صغيرة من طرفي. والبلاد العربية مصابة منذ الاستقلالات بهذه الأوبئة التي تتفاقم باستمرار”.
كوفيلاند الجزائرية

لكن كوفيلاند التي وردت في عنوان الرواية بدت أنها الجزائر، سواء في ما تشهد من أحداث أو من خلال الشخصيات والوقائع التاريخية والخريطة المكانية، علماً بأن كوفيلاند تنطبق على كل مدن العالم وكل البلدان. ماذا أراد أن يقول بتسميته الجزائر كوفيلاند؟ يقول: “نعم، من خلال بعض العلامات الصغيرة يبدو الأمر كذلك، لكن لم يرد اسم الجزائر في الرواية مطلقاً لتوسيع أفق صدى الرواية من حيث أهدافها ومراميها. الوباء الرمزي كما سميته مسّ العالم من فساد ونهب وتبذير وجريمة وتهريب مخدرات. أو استرجاع للعشرية السوداء، ولو أن كل بلد عربي عاش عشريته الخاصة مثل لبنان والعراق، وبلدان أخرى، ولكن في الرواية أوبئة أخرى نجدها مُستشرية في كل البلاد العربية، من حيث وضعية المرأة التي تعاني الأمرّين، على الرغم من المساحيق هنا وهناك. لا وجود لها في المشهد السياسي أو في الحريات الذاتية، وهشاشة الدولة، فقد دمر بنياتها وقوضها بما يتماشى ومصالح النظام الدولي الجديد/ القديم. لهذا أقول إن الرواية ليست فقط معنية بما يدور في الجزائر من عصابات رهنت مستقبل البلاد، وتشكيل كارتيلات التهريب والمخدرات، ولكنها معنية بغالبية الدول العربية. حتى تسمية البلاد التي تدور فيها الأحداث كوفيلاند، أي أرض وباء “كوفيد”، لم تأتِ اعتباطاً، ولكن لتأكيد أن هذا الوباء تغلغل في المجتمعات العربية”.
الخريطة العربية
يشرح الأعرج فكرة النموذج المديني: ” أتحدث هنا عن الوباء الحقيقي، ولكن أيضاً الوباء الرمزي من فساد ونهب. وبقراءة متبصرة سترى في المدينة المذكورة شيئاً من الجزائر، ولكن أيضاً شيئاً من بغداد، دمشق، الدار البيضاء، وغيرها. كوفيلاند هي جماع البلاد العربية. أنا أعرف العالم العربي جيداً، وقد عبرته طولاً وعرضاً، وأحبه، لأني اخترته لغوياً وتاريخياً، ولكني في الوقت نفسه حزين عليه لأني أعرف جيداً أن الآتي سيكون تراجيدياً، وقد بدأت علاماته تظهر هنا وهناك. ولا أظن أنني مخطئ في تخوفاتي في رواية العربي الأخير التي اعتبرها الكثيرون نصاً يائساً، ليس يائساً، ولكنه نص تراجيدي. لأن جشع الاستعمار الجديد كبير، تهمه مصالحه في المقدمة. العالم انحصر اليوم في أميركا وإسرائيل، ويمكن إضافة بريطانيا، على حد ما، الباقي كومبارس، بما في ذلك أوروبا التي تحاول أن تدافع عن نفسها قبل فوات الأوان. وهذا كله سيضع العالم العربي على حواف شديدة الخطورة قد تزيله من على الخرائط كفاعلية، وتدخله في صراعات عرقية وإثنية وطائفية وجهوية، وفي حروب أهلية سيدها الدين في صوره الأقل إشراقاً، وتظل إسرائيل هي المتحكم الأول والأخير في كل التحولات اللاحقة. أين المفر سوى حماية النفس بالقاتل نفسه؟”.
العائلة المفككة
يقدم واسيني الأعرج نموذجاً للعائلة الجزائرية المضطربة، فالأب قاسٍ وأصولي، والابنة متحررة ترفض الزواج التقليدي المدبر وتقع في حب شخص آخر، والأخ منغمس في الملذات ويتاجر بالمخدرات… ما خلفية هذا التقديم للعائلة الجزائرية التي تعيش حال التفكك والانهيار؟ يبرر واسيني هذه النزعة التفكيكية قائلا: “هذه ليست صورة العائلة الجزائرية. انظر من حولك، وسترى ببساطة أنها صورة العائلة العربية، صحيح أن التطورات المعاصرة فككت قليلاً البنية الهرمية للعائلة التقليدية البطريركية. العائلة العربية تعيش حالة يأس انهارت فيها كل التوازنات التي كانت موجودة سابقاً. الأب قد يكون متفتحاً مع بناته وأولاده، والأبناء خريجو المدارس والجامعات، أكثر تطرفاً وأصولية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن حلقات التطور تسير بالمقلوب. ثقافة الأبناء مسيسة دينياً، وليست ثقافة تسامحية للأسف. المدرسة مسؤولة عن ذلك. وقد يفرض الابن سلطانه على العائلة، ويصبح هو الأب، خصوصاً إذا كانت شخصية الأب ضعيفة. هذا كله يدفع بنا إلى طرح هذه الأسئلة القلقة. هل نسير إلى الأمام؟ أم نسير نحو حتفنا ونحو المزيد من التخلف؟ في الفترة البطريركية كان التوازن يأتي من التراتبية، اليوم لم يبقَ شيء من هذا. انظر إلى جرائم الشرف، يفترض أن تعلمنا مثل هذه الحالات ثقافياً، الكثير من ضبط النفس والتأمل واعتماد القانون كمرجع ومسؤولية. من دون سؤال، يذهب الأخ ويقتل أخته، أو الأب ابنته ستراً للعار؟ أي عار؟ والقانون يجد كل مبررات وضع الأب خارج القانون بالتماس الأعذار. الرواية خاضت هذه التجربة بعلامات جزائرية، ولكن بعمق مسّ المجتمع العربي في كليته لأنه يتشابه بشكل كبير”.
السرد وفن الرسالة
يسعى الكاتب في “ليليات رمادة” إلى كتابة رواية شبه شاملة تتداخل فيها عناصر عدة: فن الرسالة (إبيستولير)، اليوميات، الأحداث، الوقائع، المواجهات، التشويق، رواية العائلة، التاريخ… ما كان حافزه إلى كتابة مثل هذا المشروع الروائي؟ فرمادة تقوم بمهمة السرد بكتابة الرسائل إلى حبيبها العازف الموسيقي شادي يعقوب، ويلحظ القارئ أن السرد وكتابة الرسائل يتداخلان بعضهما ببعض، وكأنهما خاضعان لنسيج واحد ورؤية واحدة. هل تقصد هذا؟ ألم يكن من الأفضل أن تختلف الرسائل عن متن السرد اختلافاً أوسع؟ يجيب: “لم يكن الأمر كذلك في بداية الكتابة. كان في نيتي بشكل تقليدي أن أكتب يومياتي في انتظار الموت، لكنّ هذا اليأس لا يشبهني. ثم أية يوميات في وضع ستاتيك. النظر من الطابق الأول إلى شارع خالٍ، في مشهد يومي متشابه لا يضيف شيئاً جديداً دون الانغماس في الذاكرة. باستثناء سماع الأخبار هنا وهناك وتتبع تصاعد أرقام الوفيات وعجز الطاقم الطبي عن فعل الشيء الكثير بعد أن تفاقمت موجات الوباء. بصراحة، بدا لي الأمر عبثياً، بل وغبياً أيضاً. كنت وقتها في رواية حب عن القصة العظيمة لـ”حيزية” التي كنت انتقلت من أجلها إلى الصحراء الجزائرية، لكن ذهني كان مشتتاً، ورفضت أن أشتغل عليها، لأن موضوعها بدا لي بعيداً عما كنت أعيشه. وفجأة لمعت في رأسي فكرة كتابة رواية حية تتحدث عن الوضع الذي كنت فيه، والذي يمس الإنسانية قاطبة من خلال جائحة لا يمكنها أن تمر بسهولة”.
“طاعون” ألبير كامو
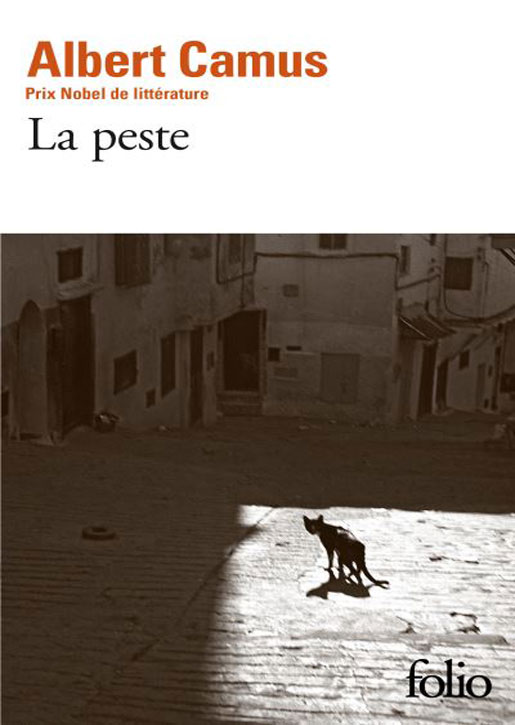
يتطرق الأعرج الى رواية “الطاعون” مضيفا: “كنت قد قرأت رواية “الطاعون” سابقاً، فجأة وجدتني أتجه نحوها من جديد، وأثناء قراءتها لمعت فكرة أخرى في رأسي: لماذا لا أترجم هذه الرواية بإحساس وبائي لم يكن متوفراً للمترجمين ولا حتى للكاتب؟ الترجمة من عمق الوباء شيء مذهل. لا بد أن هناك شيئاً ما سيكون عاضداً للترجمة الجيدة. قرأت كل الترجمات العربية لهذه الرواية، وأحسست بخلوها من هذا الإحساس المرتبط بالخوف، بل بالرعب الذي أدى إلى نكران المرض. ضبطت برنامجاً قادني نحو فكرة إعادة ترجمة كل النصوص الروائية لألبير كامو. وصلت إليّ في عز الحالة الوبائية، تحية من المعهد الفرنسي في الجزائر، وبدا متحمساً للمشروع. فأصبح المشروع حقيقة، لكن ذلك لم يكن كافياً لإخراجي من فكرة الموت. لهذا، كما ذكرت سابقاً، فرضت الرواية نفسها عليّ بقوة لأنها التعبير الأسمى والأعقد عما في داخل الإنسان من ارتباك وغموض ورغبة في الحياة. وبنيت الرواية أولاً على سردية تخييلية مرتبطة بيوميات الوباء الذي لم نكن نعرف كيف سيتطور وكيف سيكون منتهاه، وهل سيمنحني مثلاً، الموت فرصة إنهاء الرواية؟ وهل سأفقد الأعزّاء لأدخل في نوبة حزن قد لا تنتهي إلا بنهايتي؟ أسئلة فنية ووجودية مهمة انتابتني في حالة مثل هذه. ثلاثة عناصر فنية اخترقت بنية هذه الرواية من خلال شخصيات كثيرة أهمها شخصية رمادة، طبيبة المختبر، أو أفين، والموسيقي شادي يعقوب”.
السردية الكلاسيكية
عن اللعبة الروائية المعتمدة يقول: “كانت السردية الكلاسيكية شيئاً ضرورياً لأن الرواية مبنية على فعل الحكي اليومي الذي يتأسس في القصة المفترضة أو الحدوتة التي تشد انتباه القارئ المحترف والعادي المحب. استعمال الرسائل كان ضرورياً أيضاً للتعبير عن أعماق الإنسان في لحظة خوف ووجدان، يتم من خلالها توصيل صورة اليومي لحبيبها، ولو أن المفارقة العجيبة هي أن حبيبها لم يكن قادراً على القراءة، لأنه كان في حالة “كوفيد” متقدمة ارتبطت بعسر التنفس والعجز عن الحركة. كانت تعرف ذلك، ولكن كان عليها الكتابة والحكي اليومي لتشعر براحة، وأن الذي تحبه يقاوم الموت. كانت تكتب له، ولكنها في النهاية كانت تكتب لها، أو لنفسها أيضاً لتتوازن في عالم فقد أي توازن. الرسالة رسمت الحالة الداخلية لراما، أو رمادة. من الناحية التقنية، كانت العمليات السردية مفصولة بشكل واضح عن الرسائل، أولاً بالترقيم، حتى لا يقع أي لبس، وثانياً باستعمال الخط المائل بالنسبة للرسائل، وهي تقنيات بصرية تخفف الجهد على القارئ، إذ بمجرد ما يدخل في نظام الرواية يكتشف الطريقة المعتمدة”.
التقطيع الموسيقي

ويتحدث عن اللعبة الموسيقية في الرواية: “العنصر الثالث الذي شيّدت عليه الرواية، هو الموسيقى المرتبطة بالرسائل بشكل حميمي. ليليات شوبان Les Nocturnes de Chopin، وهي مقطوعات موسيقية رومانسية ليلية في أغلبها، قصيرة مشحونة عاطفياً، كان يعزفها على البيانو عادةً. وهي تعتمد أيضاً على نظام داخلي خاص قريب من تحولات رمادة الداخلية وقسوة ما كان يحيط بها وببنية الرواية أيضاً. تتكون الليلية من اللحظة البدئية التي تشكل افتتاحاً A، ثم التيمة التي يريد الموسيقي إدراجها، والتي كثيراً ما ارتبطت باليوميات التي تترك عمقاً في النفس B، ثم اللحظة الثالثة هي العودة إلى اللحظة البدئية A، مع تنويعات خفيفة تقول دورة الحياة في تشابهها وتكرارها، ولكن أيضاً في انفلاتها الساحر، وتصبح تركيبة المقطوعة، أو الليلية ABA، وفق نظام لم يكن بعيداً عما كانت تعيشه رمادة. استعمل شوبان للتأثير أكثر على مستمعه إيقاع B majeur، أو mineur، التي تحدّ من انفلات الخيالات، وكثيراً ما تنتهي إلى الروندو Rondo، أي الشكل الدائري ABAB الذي كان يجسد حياة رمادة اليومية. ولا عجب في أن يذهب القارئ نحو الليليات الموسيقية التي تجاوزت العشرين، ليتعرف عليها، وهذا سيكشف له بعض أسرار الرواية. إذا كان السرد جسد الرواية، والرسائل عينيها، فالموسيقى روحها”.
البطلة القارئة
البطلة التي هي الراوية، متخصصة في العلوم المختبرية وتعاني من ذكورية زوجها، لكنها في الوقت ذاته قارئة مهمة، تجيد ثلاث لغات، إضافة إلى العربية، لا تحب الرواية التاريخية، تقرأ الرواية الأوروبية الشمالية، وبخاصة البوليسية، عطفاً على قراءتها عيون الأدب الروائي العالمي. هل ثمة مبالغة في رسم ملامح هذه الشخصية الرئيسة في الرواية؟ هل حمّلها الأعرج بعضاً من همومه وثقافته الروائية، فارضاً وجهة نظره عليها؟ يتحدث واسيني عن هذه الناحية في فنه السردي قائلاً: “ربما ظهرت رمادة أحياناً كبطل مضاد لي ولقناعاتي، أنتي-واسيني Anti-waciny من خلال بعض تصرفاتها. مثلاً الصبر الذي تحلّت به في حياة زوجية ميتة وغير نافعة انتهت بها إلى اليأس وإلى كسور داخلية كان من الصعب رتقها حتى نهاية الرواية، ثم كرهها للرواية التاريخية مع أن هذا النوع هو حبي الأساسي، وربما الأول أيضاً. فقد بدأت حياتي بالرواية التاريخية. فأنا وُلدتُ في الحرب، وكبرت فيها وحملت جرحها من خلال استشهاد والدي والكثير من أعمامي، رحمهم الله، جميعاً. أول ما كتبت كان والدي مثلي الأعلى. وكان جدي من خلال مرويات جدتي مثلي العريق في مقاومته لمحاكم التفتيش المقدس. من الصعب عليّ أن أفلت من ذلك. كنت مصوراً لما ترسّب في داخلي من وقائع وأحداث، لكن منذ رواية “رمل المايا/ الليلة السابعة بعد الألف”، وبعدها “كتاب الأمير”، أصبح التاريخ في رواياتي شيئاً آخر. مادة اختبارية وليس حقائق مطلقة، ومن هذه المادة الاختبارية تنشأ نصوصي. أدركت وقتها أن التاريخ الذي نقرؤه اليوم وقرأناه سابقاً هو تاريخ المنتصرين، مما يعمق تفرد شخصية رمادة عني، فهي في عالم آخر، هو عالم الطب، أي إن الانشغالات بعيدة، وربما اشتركنا في شيء عميق هو المقاومة وعدم الاستسلام حتى لقوانين الطبيعة. فهي تشبه الكثيرين في الحياة اليومية البسيطة للناس. ما عاشته وقالته يتقاطع مع حياة بشر يحيطون بنا ولا نعرفهم. ولا تستغرب إذا قلت لك إن الرسائل التي وصلت إليّ كثيرة وكبيرة، وكلها من إناث يؤكدن أنهن شبيهات لرمادة في حياتهن وصراعهن اليومي مع أزواج لا حب ولا رحمة في قلوبهم. هي صورة خاصة، ولكنها عامة أيضاً مرتبطة بالوضع الاعتباري للمرأة في المجتمعات العربية الإسلامية التي لم ترتق على شروط المرأة المعاصرة التي تمتلك كماً من الحقوق يجعلها في منأى من الاعتداءات الذكورية. قوانيننا التحررية في هذا السياق ليست أكثر من حبر على ورق، ولا تزال المرأة تقتل لأتفه الأسباب في مجتمعات الأعراف واللاقانون”.
الرواية الكورونية
هل يصف روايته بالرواية الكورونية، أم أنها مقاربة سردية تحت وطأة كورونا؟ ومن الملاحظ حتى عالمياً، أن الروائيين تأخروا في كتابة روايات كورونية، أو لعلهم يترددون. وبعضهم كتب يوميات الحجر ومذكرات ونصوصاً، أما روائياً فلا. كيف ينظر واسيني إلى هذه الظاهرة؟ هل ستتطلب رواية كورونا العربية والعالمية مزيداً من الوقت؟ يجيب: “في الكتابة هناك ثلاث إمكانات تتمظهر الكتابة الروائية من خلالها بقوة: إما كتابة رواية عن حالة وبائية مثلاً، ما دام الأمر يتعلق بـ”كوفيد”، بعد مرور عقود وسنوات، وربما قرون. وهذا ممكن أن يكون. لا مشكلة. نكتب في هذه الحالة، ونحن ننصت للتاريخ بعين ناقدة، نكتب اعتماداً على الوقائع والسير والمرويات، ومن خلال أصوات الآخرين التي نحاول توليفها روائياً. لا مشكلة مطلقاً في هذا”.
ويوضح فكرته: “يمكننا أيضاً أن نكتب عن اللحظة في عز تكوّنها واشتعالها وحدوثها، وفي هذا مزية، لأننا نعيش ظرفية استثنائية لا تتوفر للجميع، لكن الكتابة هنا ليست معزولة عن سياقاتها التاريخية. في اللحظة التي أكتب فيها عن الحاضر فأنا مرتبط بقوة بالوباء في عهد عمر بن الخطاب، عام الرمادة، مرتبط بالمقريزي، وكذلك بمرويات ابن خلدون وغيره. ما يبدو كتابة اللحظة ليس كذلك. وهذا مرتبط بحرفة الكتابة لدى الروائي، لدرجة أن يتحول وباء كورونا مثلاً إلى مطية لقول وباء آخر هو وباء الفساد والمخدرات والديكتاتوريات العربية والاقتراب من صوت التكسّرات التي تحدث في أعمدة المجتمع العربي وهي تنهار، بمعنى أن الوباء يصبح ديكوراً لشيء أكبر منه. طبعاً في هذه الحالة علينا أن نتفادى شيئاً مهماً، وهو ألا تبقى الكتابة رهينة التوصيف، فتتحول الرواية إلى مجرد سرد للأحداث. الرواية أولاً وأخيراً قصة تخييلية وبناء حقيقي. نحن لسنا في صدد يوميات يكون فيها الوفاء كبيراً لما يحدث أمام أعيننا، وكلمة رواية في هذا السياق تعني الكثير، وعلى رأسها الخاصية الفنية. لهذا لا أعتقد حقيقةً بوجود رواية كورونية، بل أجد التسمية من الناحية النقدية غير موفقة، الكورونية ليست نوعاً، قد تنتمي أكثر إلى الرواية التاريخية إذا ارتبطت بالوقائع والتفاصيل، لأنها ترسم حقبة تكوّنت، أو هي بصدد التكوين. هناك حالة ثالثة، قد يستبق الكاتب الأحداث ويكتب رواية عن وباء سيأتي على البشرية، كما رأينا ذلك في كثير من الروايات والأفلام العالمية التي أعيد بعثها من جديد، بسبب خطأ طبي، أو تسرب إشعاعي. القصد من وراء هذا التحليل التأكيد أنه لا يوجد ما يمنع من الكتابة في اللحظة نفسها، أو بعدها بزمن قد يطول، وقد يقصر، أو حتى بشكل قبلي افتراضي، بتصوير شيء غير موجود زمن كتابة الرواية، ويأتي التاريخ ليؤكد أو يدحض ذلك”.
الكاتب – عبده وازن
https://www.independentarabia.com/node/263996






